البحوث العلمية لدى الهيئات المصرية قاموا بوضع الهندسة العكسية

البحوث العلمية : “لست أفضح سرًّا إذا قلت إن عرقلة البحوث العلمية لدى الهيئات المصرية جميعًا وعرقلة التقدم التكنولوجي من ورائه، والوقوف بالثروة المصرية أن تتقدم، وبالإصلاح أن يكون… ترجع أكثر أسبابه إلى أن أولي الأمر منا لا يؤمنون إيمان العجائز بالبحوث العلمية، إلا إطراء على الأوراق، أو رنينًا في قاعات الخطابات ودور البرلمانات” هكذا تكلم الدكتور أحمد زكي الأب المؤسس للمركز القومي للبحوث حول غياب دور مؤسسات البحث والتطوير في ترقية الصناعة، وهو الاقتباس الذي نقله عنه الدكتور محمد بهاء الدين فايز في كتابه “الارتقاء التكنولوجي في الصناعة المصرية ودور مؤسسة البحث والتطوير” الصادر هذا الشهر (العدد 243 – ديسمبر 2007) ضمن سلسلة “كتاب الأهرام الاقتصادي” والذي يقدم فيه تشخيصًا و”روشتة” علاج لأزمة تطوير الصناعة المصرية. ويدور الكتاب حول محورين رئيسيين:
المحور الأول: التفرقة بين دور مؤسسات البحث العلمي، ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، وتشخيص المعضلة المصرية في انحراف تلك المؤسسات عن هدفها الذي أنشئت من أجله.
المحور الثاني: وضع روشتة علاج لتلك الحالة يتمثل في ضرورة وجود تشريع يعيد تلك المؤسسة إلى أصل نشأتها؛ لتمارس دورها في ملاحقة التطور التكنولوجي الصناعي من خلال ممارسة “الهندسة العكسية”.
ففي الفصول من الثاني حتى الرابع يعالج المؤلف أصل المشكلة، مشيرًا إلى أن تأسيس “المركز القومي للبحوث” جاء ليكون مؤسسة للبحث والتطوير الصناعي، وقد رسم الأب المؤسس للمشروع مسيرتها منذ البداية لـ”تبدأ بالعلم الأساسي وتبني عليه لتخاطب الاقتصاد الوطني قبل وفوق أي خطاب بتعبيرات السلع والخدمات والتي نعرف من خلالها أن الرواج الاقتصادي لا يكون إلا بالمنتجات تنافسية الخصائص، تصديرية التوجه”، ووضع التصور التفصيلي للمباني والمعامل والتجهيزات، ودبّر التمويل وأوفد عددًا من شباب الخريجين للخارج في مجالات البحث والتطوير الصناعي، وكان أن اكتمل البناء وعاد الخريجون من بعثاتهم وقاموا بتدريب شباب جدد من الخريجين على ما تدربوا عليه “بهدف أن تتكون في إطار معقول من الزمن الكتلة الحرجة من البشر والخبرة التي تتحمل أن تناط بها المهمة الكبيرة: خدمة الصناعة الوطنية وتوليد المقدرة (أي التكنولوجيا) التي يحتاجها الإنتاج والتي تغني عن استيراد السلع الأجنبية وتكنولوجيات إنتاجها”.. ومضت السنون وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتعددت السلبيات التي تعطل أو تعوق المسيرة، فترك الأب المؤسس مصر.. وحادت المؤسسة عن طريقها، وصار همّ الباحثين فيها هو تحصيل الشهادات، ونشر البحوث، وتحصيل الترقيات..
بين البحث العلمي والتكنولوجي.. فروق جوهرية
بين وضوح الرؤية لحظة البداية، وبين ضبابيتها حين المسير يفرق الدكتور فايز بين مطلبين، مطلب العلم والبحث العلمي الذي مالت إليه المؤسسة في مسيرتها، ومطلب التكنولوجيا والبحث والتطوير وهو مطلب التأسيس والرسالة المنسية:
البحث التكنولوجي
البحث العلمي
يخاطب في المقام الأول منتج (سلعة أو خدمة)، وهو ينشئ مقدرة تتأسس على المعرفة
يخاطب قضايا وظواهر، ويبدأ بالمعرفة، ويتأسس عليها طلب المزيد من المعرفة
نقطة البداية هي الحاجة، ولا تكون النهاية إلا مع الوفاء بتلك الحاجة
نقطة البداية هي الفضول، وقد لا تكون نقطة نهاية حتى مع إشباع الفضول
لا يصح في الغالب نشر النتائج بسبب قيمتها التجارية المحتملة، بل يلزم حجبها إلا عن الطرف الذي يعتزم استغلالها
لا بد من نشر نتائجه ليعلم بها الكافة ولا يصح أخلاقيا حجبها
يعتمد على الرؤى والمبادرات والقرارات المؤسسية، وهو لذلك موضوعي التوجه
يعتمد إلى درجة كبيرة على المبادرات الشخصية، وهو لذلك ذاتي التوجه
يرحب الباحث بالمشروعات التكليفية؛ لأنها تعتبر اعترافًا بقدراته واحترامًا لحرفيته
لا يرحب الباحث العلمي عمومًا بالمشروعات التكليفية؛ لأنها تمثل تعطيلاً لحقه في ممارسة الحرية
في الأعمال الكبيرة تتخذ الاجتهادات في الفكر الممارسة طبيعة الملاحقة التي يقتصر الطموح فيها على طلب اللحاق بالسابقين
في الأعمال الكبيرة يكون البحث رياديًّا في فكره ومستواه وأدائه حتى يحقق الثمار الكبيرة التي قد تكون من نوع الاكتشافات
النتائج المطلوبة تكون معلومة التجسيد سلفًا، وقيمتها التجارية مؤكدة
في كثير من الأحوال لا تكون للمعارف المولدة قيمة مادية مباشرة
بسبب خصائصه الموضوعية فإن الباحث يعمل لخدمة المشروع في إطار فريق ينفض بعد إتمام المهمة ليدخل في فريق آخر..
بسبب خصائصه الذاتية قد يعمل الباحث طوال حياته في مجال واحد لا يفارقه
تتحدد التزامات الباحث قانونًا وسلوكًا باحتياجات وأهداف المشروع
يقتصر التزام الباحث قانونًا على اتباع أحكام قوانين ولوائح المؤسسة ومثيلاتها
مساراته خطية وإنجازاته قابلة للتنبؤ، بل محسوبة ومتوقعة ومطلوب بلوغها
غالبًا ما تكون مساراته لا خطية زمنًا ومكانًا وشخصًا، ومن ثَم تكون إنجازاته غير قابلة للتنبؤ
لا يصعب تحديد ما يكفي من المال والوقت
يصعب تحديد ما يكفي -مالاً ووقتًا- لتحقيق الهدف المطلوب
الأغلب أن يكون له مستفيد محدد مسبقًا وثمرته تتجسد في منتج (سلعة أو خدمة)، ويتعارض نشر النتائج مع مصلحة المشروع
لا يعرف له سلفًا مستفيد محدد، ولا تتجسد ثمرته في هيئة منتج، بل رسالة أو بحث علمي للنشر والإجازة والجائزة
تنال المؤسسة المال من صاحب المصلحة في البحث، وقليلاً ما يكون للتعاون مع جهات أجنبية دور جوهري
في أداء المؤسسة لوظيفتها قد تنال تمويلاً تشارك به أطراف أجنبية
إيفاد العاملين لشهود المعارض التجارية ومعرفة أحدث المنتجات ووسائل صنعها (ضرورة حياة للمؤسسة)
إيفاد العاملين في المؤسسة لشهود المؤتمرات ومعرفة الجديد
في أداء المؤسسة يحكمها البراجماتية والأخلاق السوية، والهندسة العكسية هي ممارستها اليومية
في أداء الفرد الباحث يلزمه القانون الأخلاقي والأمانة العلمية
“روشتة” العلاج.. التشريع أولاً
وفي رؤيته للحل يضع الدكتور فايز التشريع أولاً، حيث يرى “أن موضوع التشريع ودوره في مؤسسة البحث والتطوير التي تعمل في مصر بالاحتراف والتفرغ هو عمل وطني قد تأخر لأكثر من خمسين عامًا، وأن الأذى الذي نتج عن غيابه قد تضاعف وتعقد؛ بسبب القصور المزمن في السياسات التي يتوجه بها العمل، وبسبب القصور المصاحب والمزمن أيضًا في الموارد المالية”، ورغم ذلك يعترف “بأن التشريع مهما كان محكمًا وصحيحًا لا يكفي وحده لتفعيل دور مؤسسة البحث والتطوير وبلوغ رسالتها إلى مواقع التأثير في الاقتصاد الوطني”. أما العناصر التي يقترحها لتطوير البيئة التشريعية لعمل المؤسسة:
1. بأنها تعمل بالاحتراف والتفرغ وتستهدف في المقام الأولتوليد التكنولوجيا التي تلزم لخدمة الإنتاج في مصر.
2. القوة البشرية العاملة: من حيث تحديد معايير الاختيار، والترقية، والإيفاد بما يتوافق مع الرسالة.
3. اختيار رئيس المؤسسة: بحيث يكون على إدراك والتزام بالرسالة، ويتمتع بحس سياسي – اقتصادي يدرك من خلاله توجهات الاقتصاد العالمي المؤسس على التكنولوجيا، وأن يتمتع بخصائص وهمة الشباب، وأن يكون متمرسًا في بحوث التطوير التكنولوجي.
4. أداء العاملين وخصائصهم: فعلى العاملين في المؤسسة إدراك التمايز بين رسالة المؤسسة وغيرها من مؤسسات البحث العلمي البحت، وأن يمتلكوا قدرات البحث العلمي والتكنولوجي، ويمتلكوا قدرًا من حواس التنبه لما يجري في العالم من استحداث لأجيال من السلع والخدمات، وتكون لديهم القدرة على العمل في فريق، ويكونوا مستعدين للتنازل عن مزايا البحوث العلمية، وأن يمتلكوا إلمامًا بقانون الملكية الفكرية.
5. التنظيمات الداخلية وإدارة الأنشطة: يبنى العمل في الأساس على التنظيمات الرأسية الموضوعية لفرق العمل والتي تعمل وفق أنشطة البحث والتطوير التكليفية.
6. التمويل الكافي لإدارة العمل: فلم يَعُد متصورًا أن تتواصل الضائقة المالية التي يعانيها البحث والتطوير في مصر، وقد سبقنا إلى الفكاك من هذه الحالة كثيرون، وينفعنا أن نقتدي بسلوكهم ونأخذ من نماذجهم.
في الفصلين الخامس والسادس يشير الكاتب إلى الهندسة العكسية التي تتكون -كما يقول- من مرحلتين متعاقبتين ومتكاملتين، الأولى تحليلية وتهدف للسيطرة الكاملة على السلعة من خلال فحص واختبار السلعة في كل تفاصيلها وتفاصيل مكوناتها بهدف معرفة وقياس واستيعاب كل دقائق الكم والكيف فيها (Know-What)، وفهم علاقاتها جميعًا بخصائص السلعة وأدائها (Know-Why)، أما الثانية فهي تشييدية، ويجري فيها استنباط الوسائل التي تصنع المقدرة على بناء سلعة مثيلة لتلك التي يبدأ بها العمل (Know-How)، ثم الإضافة عليها إن أمكن إضافات ولو طفيفة تتراكم مع الوقت لتصبح إضافات جوهرية. وتعتمد دعوته لاعتماد الهندسة العكسية أسلوبًا للعمل على الدواعي التالية:
1. فالهندسة العكسية تعترف بالعالمية في المعرفة والمقدرة التكنولوجية، وتعتمد على ما أتاحته من منتجات بات مجرد عرضها كافيًا لإيجاد الطلب عليها.
2. حتمية التغيير: فهي الطريق لإحداث التغيير المتسارع المطلوب في مصر والذي يتحقق من خلاله الارتقاء التكنولوجي كسبيل وحيد للنجاة.
3. التنافسية: التي باتت مطلبًا عالمي النطاق لكل نشاط محلي لإنتاج السلع أو الخدمات.
4. الرؤية والعزيمة السياسية: فالقرار باعتماد الهندسة العكسية سبيلاً ومنهج عمل ينبئ عن رؤية وطنية وعزيمة سياسية.
5. نموذج اليابان: فقد كان أسلوب الهندسة العكسية سبيلاً اتبعته على الأقل في المراحل المبكرة من مسيرتها للتنمية الصناعية.
6. الخلاص من الدائرة المفرغة: فممارسات الهندسة العكسية الناجحة كفيلة بكسر الدائرة المفرغة التي يعيشها البحث والتطوير في مصر: دائرة الإنجاز العلمي غير المترابط بالتطور التكنولوجي.
7. الامتلاك البيولوجي: فهي تتأسس على، وينتج عنها كذلك مكسب التعلم ذو الإحاطة الجامعة بما بلغه الآخرون من تقدم علمي وتكنولوجي.
8. تحديث الصناعة: ففي ضوء الهندسة العكسية يمكننا أن ننجز البرنامج القومي لتحديث الصناعة.
9. المصل الواقي: فهي المصل الواقي من حالة التدهور المهني في فكر وأداء الجماعة مع الوقت، فأنشطتها تتنوع كل يوم بتنوع صنوف السلع والخدمات.
10. روح الفريق: فهي تفرض روح التعاون والتكامل والاعتماد المتبادل بين عديد من التخصصات والخبرات.
وقد رصد الدكتور فايز عددًا من دواعي القلق التي قد تمثل عائقًا أمام تعديل مسار مؤسسات البحث والتطوير، وتبنّي الهندسة العكسية سبيلاً للخلاص، من بينها:
* أن التغيير بحد ذاته أمر لا يرحب به الكثيرون، مما قد يثير مقاومة بعض العلماء للتحول نتيجة ألفتهم مع ممارسات البحث العلمي الصرف، وخشيتهم من تقلص المكاسب الأدبية المتمثلة في النشر العلمي، وانعدام خبرتهم في التعامل مع الآخر (جانب التلقي في الصناعة).
* أن الهندسة العكسية غير مألوفة أو واسعة الانتشار في مصر، والمكسب الآتي منها تحكمه اعتبارات السوق.
* عدم اقتناع رجال السياسة وصناع القرار بالتعديل، إضافة إلى قناعة الصناعيين بأن “الخواجة” قادر على كل شيء.
ترى هل تلقى دعوة الدكتور فايز في كتابه هذا آذانًا صاغية في وسط ضبابية المشهد السياسي في مصر، أم أنها تلقى كما لقيت دعوات سابقة آذانًا صمًّا، وقلوبًا عميًا؟!
مجدي علي سعيد
نقلا عن إسلام أون لاين






./1126-220x150.jpg)



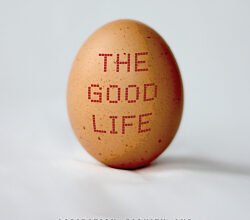
./1310-360x220.jpg)
./1191-390x220.jpg)

