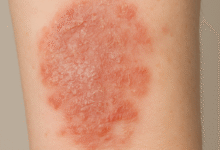الربيع الفائت..في محنة الأوطان العربية أصولا وفصولا
في مقدمة كتاب الربيع الفائت، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (280 صفحة بالقطع المتوسط)، يقرّ مؤلفه أحمد بيضون بأن “هذا الكتاب ليس سيرةً للحركات التي أطلقنا على أوائلها اسم ’الربيع العربي‘، ثمّ تحيّرنا في اختيار اسمٍ لتواليها، ولا هو سيرة لمؤلّفه، في أعوام قليلةٍ مضت، بما هو واحد من الذين اختاروا التأمّل في هذه الحركات طريقةً لمداراة استغراقهم فيها ولحفظ انتسابهم إليها في آن. في الحالين، تقتضي السيرة تعمّدًا للإحاطة واتّساقًا مأمولًا لا يدّعيهما هذا الكتاب؛ فهو من جهة ’الحركات‘ مجموع مقالات تحكّم بها اختلاف المناسبات وتعاقب الأوقات طولًا أو قصرًا ومداراتٍ وأوصافًا أخرى، وهو من جهة المؤلّف مرايا في بعض مواضعه، وأقنعة في بعضٍ آخر”.
في الفصل الأول من الكتاب، في المطالع والأصول: حركات التغيير العربية من إرث السلطانية المُحدثة إلى التشييد المؤسسي للديمقراطية، يصنف بيضون الأنظمة العربية التي ضربتها حركات التغيير على أنها “أنظمة إرثية محدثة” أو “أنظمة سلطانية محدثة”، فيتبيّن له عند التدقيق أن السلطانية هي نفسها الإرثية “لكن بقدر مضافٍ من حدّة الملامح والأوصاف”.
يقول: “ندرج بعض الأنظمة العربية التي سقطت أو تبدو آيلة للسقوط في خانة الإرثية، وبعضها الآخر في خانة السلطانية. لا ريب، مثلًا، في أن نظامين من هذه الأنظمة هما نظام معمّر القذافي في ليبيا، ونظام صدّام حسين في العراق، كانت أوصافهما، خصوصًا في المرحلة الأخيرة من عمر كلّ منهما، توافق، إلى حدّ بعيد جدًّا، تصوّر السلطانية المحدثة. هذا فيما بقي نظاما كلّ من حسني مبارك في مصر وبشّار الأسد في سورية أقرب إلى الأنموذج الإرثي المحدث”. فمبارك لم يتمكّن من إفراغ مصر من السياسة ومن الحياة المدنية الحرّة، بما فيها الإعلام المستقل، بالقدر الذي نجح القذافي في تحقيقه.
كما يلاحظ بيضون أن الجمهوريات المولودة من انقلابات عسكرية بدت أكثر تعرّضًا لرياح التغيير من الممالك أو الإمارات الوراثية، علمًا أن هذه الأخيرة كانت تعتبر أكثر تأخّرًا على الصعيد السياسي من الجمهوريات التي نشأت على أنقاض الممالك ورفعت بيارق الثورة والتحرّر والتقدّم. ويرد ذلك إلى أن الجمهوريات سلبت من الشعب سلطة كانت له مبدئيًا، وقدّمت في بداية مطافها تسويغًا لهذا السلب في القضية الوطنية، ومواجهة الأعداء، أي ضرورات المرحلة.
في الفصل الثاني، معالمُ للهاوية، يبحث المؤلف في تاريخٍ للطائفية، وفي تشكل الطوائف وحداتٍ سياسية، وفي الهوية والمذهب الديني والمواطنة، فيقول إن الطائفية طائفيات، لا يسعها أن تجد موردها الراهن في انقلاب ما لموازين القوة الاجتماعية السياسية لا بين مكوناتٍ كانت أو أصبحت متقاربة الأقدار. ويسعها أن تكون طغيانًا من الأقلية على أكثرية كان استتباب الأمر لها تاريخيًا أغناها عن تغليب الاستجابة لدواعي التوحد الطائفي في مواجهة جماعاتٍ بدت مغلوبة وضئيلة الخطر على وجه الإجمال. ويلفت بيضون إلى أن الاشتراك التنافسي بين الدولة والمذهب أو الطائفة في رسم الهوية السياسية لمن ينتمون إليهما معًا “ليس بالأمر الذي يُتلقى في شرق الكرة وغربها (كما قد توهمنا أُلفتُنا له في بلادنا هذه) على أنه قاعدةٌ تامة الشرعية أو قدرٌ لا يُرد”، مشبهًا بين الأممية الشيوعية الآفلة والأممية المذهبية الصامدة، فكلتاهما “تحمل صورة للمجتمع تُحدث صدعًا فيه يتعذر لأمُه، وأن كليهما ينحو نحو رهن مصير المجتمعات الصغيرة أو الضعيفة بإرادة مجتمع كبير أو قوي تستقر في يده دفة الأممية، فيجنح بحكم موازينه الداخلية إلى تغليب دواعي حماية النظام القائم فيه ومصالحه الاستراتيجية على كل اعتبارٍ آخر”.
يحاول بيضون في الفصل الثالث، الخوف على سورية، رسم حدود التسليم الواقعي بتحولات الثورة السورية، متسائلًا: هل تسقط هذه الثورة؟ يرى أن التطوّر، في جانب الثورة، “نحو مواجهة العنف بالعنف كان ينتهي، في الواقع، لا إلى حماية الحركة الشعبية بتنوّع قواها واتساع قواعدها الاجتماعية، بل إلى الدفع بها نحو الهوامش والحلول المتدرّج محلّها، كان ينتهي إلى ما سمّي ’عسكرة الثورة‘ بما يعنيه ذلك من تغليب لأفق العسكر وأسلوبهم في الصراع السياسي ولمسلكيتهم الاجتماعية ولما يحتاجون إليه من أنواع الدعم التي يتعذّر المضيّ في المواجهة المسلّحة إن هي لم تكن متاحةً ولو على شحّ وندرة”. ومن أبرز وجوه هذه العسكرة، بحسبه، نقل الثورة “من السباحة في مياه إسلام شعبي، غائم الملامح الاجتماعية وضعيف الإلزام في السياسة، إلى إسلام آخر، ضيّق في حركيّته ومتزمّت في شعائريته”. وفي رأي بيضون، إذا سقط بشّار الأسد ولم يفتح سقوطه أفق الحرّية والكرامة في وجه السوريين، “فإن الطاغية يكون قد أسقط الثورة السورية قبل سقوطه الذي هو آتٍ لا ريب فيه. فهل يقيّض لأصحاب الثورة أن يتداركوا ثورتهم: عاجلًا قبل سقوط الطاغية أو آجلًا في صراعٍ مديد قد يلي ذلك السقوط؟”.
في الفصل الرابع، الحلول بما هي مشكلات، يثير بيضون مسألة مداواة الأوطان بتفكيكها، فيقول: “حيال هذه المسيرة المتنوّعة الفصول نحو التفكك في هذا العدد الكبير من الأوطان، وما يتخللها من عنف بلغ في بعض مواطنه درجات من الهمجية كانت عصية على التخيل، يلحّ على الناظرين في شؤون هذه الدول ومجتمعاتها، من المثقفين وغيرهم، سؤال ينطوي على استعجال فائق وعلى طاقة ضغط هائلة على النفوس والعقول: ما القول في جماعاتٍ قدّمت شواهد ضخمة على افتقارها إلى الأهلية أو إلى الرغبة في البقاء وحدة سياسية من الصنف المسمّى دولةً أو وطنًا؟” وفي مسار هذا التفكك، يرى أن اتّخاذ الوحدة الطبيعية الصغرى أو الوحدة العصبية قاعدةً لتفكيك الأوطان القائمة، باسم إرساء السلم الأهليّ، لا تختلف حظوظه في إدراك الغاية المرجوّة منه عن اتّخاذ الوحدة الطبيعية الكبرى قاعدة لدمج الأوطان القائمة باسم القوّة القومية. كما يتناول في الفصل نفسه مسألة العلمانية، فيرى أن العلمانيين العرب يشعرون بالضعف في قواعد موقفهم، فيوطّنون أنفسهم في كلّ مكان تقريبًا “على الغضّ شيئًا ما من صراحة مطالبهم ذات الصفة العلمانية المسمّاة باسمها ويرتدّون إلى مواقع ينعتونها بالمدنية”.
في الفصل الخامس، بلايا محيطة، يلمّ المؤلف أوراقًا كتبها في أوقات متفرقة، أولها بعنوان “عالم ضعيف”، يتناول فيها ضعف العالم العربي المشرذم بين ثورات وحروب، وتحوله كرة في ملعب إقليمي كبير، وثانيها بعنوان “مهديان لعالم واحد”، يعالج فيه مسألة المهدي واستخدامه مصطلحًا سياسيًا، فيقول إن صورةُ المهديّ طغت “على معظم من عداه من الأئمّة آبائه وكثُر استعجالُ فرجه على الألسنة وعلى جدران المُدُن والقرى وانتظم الاحتفالُ بذكرى ولادته وأصبح ظهورُه منتظرًا بين الحين والحين. لا لأن شيئًا جديدًا قد أثبت أن ظهوره قريب فعلًا، ولا لأن هذا الظهور مرغوب فيه، بالضرورة، من جانب الذين يجتهدون في إشاعة خبره. فإن أشد ما يسوءُ الوكيل، في حالاتٍ كثيرة، ظهورُ الأصيل. غير أن إبراز عظمة الأصيل يبقى ضروريًا، مع ذلك، لتعزيز شأن الوكيل. إذ كيف يكون نائبُ الإمام عمود الدنيا إذا لم يصبح هذا الإمامُ نفسه عمود الدين؟”. في الثالثة “زلابية”، يشبّه بيضون الضربات الجوية لداعش بـ “صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر”، في سياق تناوله الحرب التي يشارك فيها معظم أمم الدنيا على التشدد الاسلامي. وفي الرابعة “دلوا فلسطين على الصواب”، يحصي بيضون الفلسطينيين الباقين في فلسطين، فيجدهم “قرابة ستة ملايين في فلسطين التاريخية. ويقيم نحو من خمسة ملايين فلسطيني آخر في البلدان العربية، ومعظمهم في دول الطوق المحيطة بفلسطين بما فيها الأردن”، وسيفعلون شيئًا لفلسطين. يقول: “أسهل الأشياء وأصوبها أن يقال للفلسطينيين إنهم مخطئون. لكن منتهى اللؤم ألا يقول أحد للفلسطينيين ما هو الصواب؟ ليُقل لهم، في الأقلّ، إن الصواب قد مات!”. أما في الخامسة وعنوانها “المجتمع السياسي اللبناني في مهبّ هذا الربيع”، فيرى أن الموجة الثورية العربية كانت توجّه رسائل إلى القوى السياسية الرئيسة في لبنان، كان من شأنها أن تزيد من حدّة التناقضات اللبنانية، وأن تبدو متناقضة فيما بينها لكلّ المتلقّين اللبنانيين.
في الفصل السادس، مشكل المعرفة في مشكل الحل، يتناول بيضون مسألة الاستبداد بالمعرفة، فيقول إن الباحثين كانوا موضع متابعة مركّزة من الأجهزة المكلفة السهر على نفاذ المعايير الرسمية في إنتاج المعرفة بالمجتمع وبالنظام السياسي الاجتماعي، “فيظلّون عرضةً لما هو أشدّ ممّا يتعرّض له تلامذتهم، مثلًا، إذا هم حاولوا الدخول إلى الدوائر المسوّرة استطلاع الوقائع المفضية إلى طرح ما هو محظور من المسائل وتعزيز الحجج الآيلة إلى طلب التغيير السياسي. بناءً عليه، تبدو البحوث التي يمكن الرجوع إليها والبناء عليها، نزرةً حين يتّصل الأمر بدواخل المجتمعات الخاضعة للاستبداد وبتوجّهات النظام السياسي في تصريفه شؤونها وسعيه إلى حفظ هيمنته عليها”، بحسبه. كما يتناول في هذا الفصل معنيين للثقافة. واحد ضيق هو ما ينتجه المثقّفون، وثان هو جملة الأنظمة الرمزية التي تنشئها أو ترثها وتنميها أو تتداولها وتعرّف بها جماعة من الجماعات البشرية.
في الفصل السابع، إشارات وتنبيهات، يطرح بيضون السؤال الآتي: الدين في المجتمع أم العكس؟ يقول: “يرجح عند المتأمّل في تاريخ المذاهب الإسلامية وعلاقتها بأزمان نشأتها وبيئاتها وبأحوال الجماعات التي نشأت فيها، على اختلاف وجوهها، أن الدين كان يتبع تنوّع الأحوال وتحوّلاتها ويخضع لإلزاماتها أكثر بكثيرٍ ممّا يُمليها… وأن الجماعات لكانت تُطوّعه أكثر بكثير ممّا كانت تطيعه”. ويضيف: “تاريخ المجتمعات الإسلامية أرحب بكثير من تاريخ الدين الإسلامي أو المذاهب الإسلامية. ولا يجاوز الثاني أن يكون وجهًا متباين الحضور من وجوه الأوّل، ولا يردّ الأوّل إلى الثاني بحالٍ. فإن الدين لا يستوي، في التاريخ الفعلي، معيارًا عامًا معتمدًا دون غيره في سلوك الأفراد والجماعات إلا جزئيًا لجهة الأغراض واستثناءً لجهة الأوقات”.
كما يقدم في هذا الفصل قراءة لكتاب عبد الرزاق أحمد السنهوري فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية،ويضيف مقالات سابقة له: “في فشل السياسة” و”أزمة في ترتيب الزمن” و”نهاية المجتمعات”.
يختم بيضون كتابه في خاتمة للوقت الحاضر – شرور ما بعد الربيع العربي (لمحة في المصلحة والقيمة)، قائلًا إن لا بديل من اعتبار البشر الذين ملأوا الميادين حقائق، “مهما تكن عيوبُ العُدّة البصريّة التي شاهدناهم بها، ولم يصبحوا أوهامًا عبرت، بل إنهم هم الحقيقة الغامرة وهم القيمة الكبرى التي تؤسس عليها المواقف والسياسات. ولا ينتقص من حقيقتهم هذه أن قوّة القمع الموصوفة من هنا واستشراء التسلّح من هناك والنجدة الخارجية للأنظمة وتألّب الدول ذات المصلحة على الحركات الشعبية من هنالك قد ألزمت هؤلاء البشر بالانكفاء عن ساحاتهم وحجبت معظم أصواتهم”.