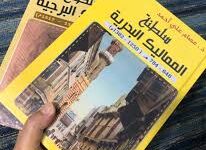صدور كتاب سلطنة المماليك البحرية والبرجية في جزئين.. باحث سعودي يضيء حقبة مهمة في التاريخ الاسلامي
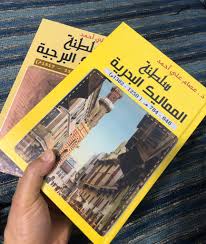
صدر مؤخرًا للباحث السعودي الدكتور عصام بن علي بن أحمد كتاب: “سلطنة المماليك البحرية في بلاد مصر والشام وبلاد الحجاز.. الكنز المفقود بين رواية شهود وروعة المشهود“.. عن دار العلم للتراث المملوكي.. في 729 صفحة..
جاء الكتاب مدعمًا بوثائق تاريخية وشهادات معاصرة، مما أضفى مصداقية وتحليلًا دقيقًا للأحداث. استخدم الكاتب أسلوبًا سرديًا يجمع بين البساطة والعمق، مما يجعله مناسبًا للأكاديميين والمهتمين بتاريخ الإسلام.
يقدم الكتاب استعراضًا معمقًا لتاريخ سلطنة المماليك البحرية، كاشفًا النقاب عن فصول منسية وشهادات مؤثرة تخص هذه الحقبة الهامة. يتميز الكتاب بنهجه التحليلي وإضافاته القيّمة للمكتبة التاريخية العربية.
ينصب اهتمام الكتاب على دراسة سلطنة المماليك البحرية، وهي إحدى أبرز الحقب التي شكلت معالم تاريخ العالم الإسلامي، خصوصًا في بلاد مصر والشام والحجاز.
يستعرض الباحث التاريخي الدكتور “عصام بن علي“، تطور هذه السلطنة، إنجازاتها، وأثرها في تشكيل مسارات التاريخ.
يتألف الكتاب من عدة فصول مترابطة، تُغطي الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تراجم لشخصيات تلك الحقبة التاريخية الهامة.
ينطلق الكتاب من تأسيس السلطنة البحرية، مرورًا بتحليل أبرز الشخصيات والأحداث، وصولًا إلى نهايتها وتداعياتها على المنطقة.
اعتمد الدكتور عصام بن علي بن أحمد (الحائز على درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي) منهجية تحليلية نقدية، استندت إلى مقاربة تجمع بين السرد التاريخي والتحليل العميق.

استشهد المؤلف بمصادر متنوعة، منها المخطوطات الأصلية، الوثائق المعاصرة، وشهادات الرحالة والمؤرخين. هذا التنوع ساهم في تقديم رؤية متوازنة وموثوقة.
يمتاز الكتاب بطرحه لرؤى جديدة حول الدور الثقافي والحضاري للمماليك البحرية، وهو جانب قلما تناولته الدراسات السابقة. كما يُبرز المؤلف شهادات معاصرة تُعيد رسم المشهد التاريخي من زوايا متعددة.
جاء الكتاب بلغة علمية دقيقة، تجمع بين السلاسة في السرد والعمق في التحليل. استخدم المؤلف أسلوبًا يجعل القارئ يعيش تفاصيل الأحداث وكأنه يشهدها بنفسه.
يقول المؤلف: لم تكن عظمة المماليك فقط في هزيمتهم للتتار في عين جالوت وغزة حمص ومرج الصفر والأبلستين. ولم تتوقف عظمة المماليك أبداً عند إذلالهم للصليبين في المنصورة وساحل الشام وقبرص وأرمينيا وفي بلاد الخوارزميين.
بل ما زالوا يبكون على ما فعله بهم الظاهر بيبرس في أنطاكية وقيسارية وحيفا ويافا وكليكيا، وحروب انتهت بوقوع أكثر من مائة ألف أسير..
لقد كانوا سادة يدبرون الممالك، وقادة يجاهدون في سبيل الله، وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل، ويردعون من جار أو تعدى وهذا ليس من قبيل الصدفة فرحم اللم المالك الصالح أيوب الذي جاء بهم لأرض مصر ثم تبعه الملوك والامراء فكانوا حقا نعم مجلوب.
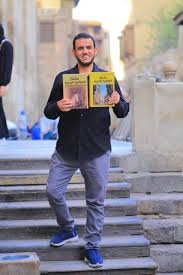
Table of Contents
التأسيس والنشأة والتسمية
سميت دولة المماليك بـ”الدولة البحرية” نسبة إلى فرقة المماليك البحرية التي كانت العمود الفقري لنظام الحكم في بداياتها. هؤلاء المماليك كانوا عبيدًا يتم تدريبهم ليصبحوا جنودًا وقادة عسكريين. أُطلق عليهم “بحرية” لأن مقرهم الرئيسي كان في جزيرة الروضة وسط نهر النيل في القاهرة، قرب البحر (النهر في اللغة العربية القديمة كان يُشار إليه أحيانًا بالبحر).
عندما تمكن المماليك من الاستيلاء على الحكم عام 1250م بعد انتهاء الدولة الأيوبية، اعتمدوا على هؤلاء الجنود في تأسيس سلطنة قوية. لاحقًا، جاءت دولة المماليك البرجية التي سُميت بهذا الاسم لأن جنودها كانوا يقيمون في أبراج قلعة صلاح الدين.
يتناول الكتاب كيفية صعود المماليك البحرية، بداية من استقدامهم كعبيد وتدريبهم عسكريًا، وحتى تحولهم إلى حكام لمصر والشام. كما ركز المؤلف على دورهم في التصدي للغزو المغولي. كما تناول معركة عين جالوت كحدث محوري في مسيرتهم. التنظيم السياسي والإداري لدولتهم.
من جانب اخر يناقش الكتاب تطور نظام الحكم، وآليات توزيع السلطة بين السلاطين وأمراء المماليك، مع استعراض دورهم في دعم الاستقرار الداخلي وتأمين طرق التجارة والحج. ويبرز الإنجازات الحضارية والثقافية والإسهامات الهائلة في العمارة الإسلامية، مثل بناء القلاع والمساجد التي مازالت قائمة حتى اليوم وتشهد على الثراء الحضاري لذلك العصر.
وتميز هذا العصر ايضا بدعم العلماء والمراكز العلمية والثقافية، مما ساهم في ازدهار العلوم والمعارف، وبرزت اسماء علماء كبار مثل ابن حجر وابن تيمية وابن القيم الذهبي والنووي والعيني وابن النفيس والسيوطي والمناوي والسخاوي والمقريزي وابن تغري بردي وابن اياس وابن خلدون والبلقيني، وابن كثير… وغيرهم.
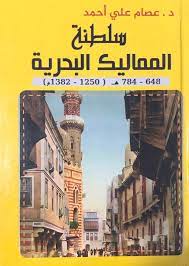
عصر العلم والتأليف
لم تكن حركة التأليف والتصنيف حدثا عابرا في تاريخ الدولة المملوكية بل هي وليدة جذور عريقة ودوافع كبرى أدت إلى هذا الثراء أبرزها السياسة التي اتبعها سلاطين بني أيوب في حسن التربية التي أولوها لمماليكهم في مختلف الميادين الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية فأصطبغت الصورة بكثير من الألوان الزاهية تطالعك حيثما توجهت او قلبت النظر. ما بين إزدهار فكري في شؤون الدين والعبادة واهتمام متزايد في اللغة قواعدها ومعاجمها وشروحها وبيانها وعروضها وقرآن كريم وعلومه “قراءات وتفسير” وحديث وسنة وفقه على مذاهبه المختلفة، وتاريخ وعلم اجتماع وآداب وعلوم إنسانية، إلى عناية بالشؤون الفنية والعلمية من فلك وطب وهندسة وحرف مختلفة وعمارة.
لذا أصبح العصر المملوكي (عصر التأليف الموسوعي)، حيث ألف كُتاب هذا العصر المملوكي آثارهم وصنفوها بموضوعية علمية ومنهجية سديدة، وشمولية في شتى فنون المعرفة نذكر منها على سبيل المثال:
(تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الجمع لأحكام القرآن للقرطبي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر العسقلاني، وفيات الأعيان وأنباء الزمان ابن خلكان، تاريخ سير أعلام النبلاء للذهبي، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروز أبادي، مختار الصحاح للرازي، الشامل في الصناعة الطبية لابن النفيس…).
يقول المؤلف: … ولو تركنا لقلمنا أن يدون أسماء الكتب والمصنفات ذات المنحنى الموسوعي لما توقف ولاحتجنا كتب ومصنفات تضم الأسماء والعناوين فقد لمؤلفات العصر المملوكي.
العصر الذهبي للطب
ويعتبر العصر المملوكي هو العصر الذهبي للطب في التاريخ الإسلامي وهذه حقيقة يجهلها الكثيرون كما يقول المؤلف، فكان هناك وفرة في الأطباء والبيمارستانات وفي العلماء من مختلف التخصصات ومنهم: (علي بن أبي الحزم المشهور بابن النفيس، الطبيب صدقة بن إبراهيم المصري الشاذلي الذي كان من ألمع أطباء العيون، وطبيب الدولة يعقوب بن إسحاق بن القف، وسعيد بن منصور بن سعد المشهور بابن كمونة الإسرائيلي وهو فيلسوف وطبيب كيميائي، وابن الدهاء الجرائحي، وابن الأكفاني، وأعجوبة زمانه علاء الدين بن عبد الواحد المعروف بان صغير… وسواهم).
فنون وعمارة نطق الحجر!
وقد استكمل المماليك نهضتهم الحضارية بتشييد معماري بديع وعمارة نطق الحجر فيها، بل أصبح من الموحدين! (كما يقول المؤلف).. وترك سلاطين وأمراء المماليك في شوارع وأزقة ودروب وحارات القاهرة الملوكية أجمل ما توصل إليه الفنان المسلم عبر كل العصور وفوق كل مكان بين قباب ومآذن وأسبلة ومدارس وخانقاوات وبيوت وبيمارستانات وقلاع وخانات ووكالات.
يقول المؤلف: “توقف القلم عن وحيه وغاب العقل عن وعيه وانتفض القلب يرفرف ويدعوا بالغفران لاناس أبدعوا في صناعة تاريخ يبقى ما بقى الزمان.
فإن شئت فاسمع موسيقى أحجار قلاوون أو قصائد عمائر الناصر وأنصت جيدا عندما تحدثك بدائع قايتباي وبرسباي وبرقوق والغوري وبيبرس والمؤيد وشيخو وصرغتمش وحسن وشعبان.
فحقا إن للدور روح ترفرف حولنا تسمعنا ونسمعها ونحن على ذلك من الشاهدين”.
دولة خالدة مترامية الأطراف
وفي الجانب السياسي أسس المماليك دولة إسلامية رائعة عظيمة خالدة مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام والحجاز وامتد حكمهم على مدى أكثر من قرنين ونصف من الزمان.
تخلل هذه الفترة مراحل الجهاد الإسلامي للدفاع عن الدين والأرض ضد الاخطار التي هددت المنطقة من الصليبيين والأرمن والمغول والغرب الأوروبي أحيانا.
أحرز المماليك باسم الإسلام انتصارات باهرة فمازالت أسماء مواقع عين جالوت ومرج الصفر والمنصورة وفارسكور وأنطاكية وطرابلس وعكا حية في التاريخ تشهد لهم بالبطولة والشجاعة والفداء وقد تحققت هذه الانتصارات بفضل جيوشهم الأكثر إعدادا والادق تنظيما.
ثم إن المماليك أرسوا نشاطا دينيا وعلميا خصبا صحب انتقال الخلافة من بغداد الى القارة، ظهر أثره في مصر والشام، من خلال إحياء شعائر الدين وإقامة المنشآت الدينية والرغبة الجامحة في الاقبال على التعليم والتأليف والكتابة.
فالدولة المملوكية من أغنى الدول بحكامها الأقوياء أمثال قطز وبيبرس وقلاوون والناصر محمد وبرقوق وبرسباوي وقايتباي الذي أسسوا دولة واسعة الأرجاء قضت على بقايا الصليبيين وأوقفت الزحف المغولي على بلاد المسلمين وخطب ودها ملوك أوروبا وآسيا آنذاك”.
“والعصر المملوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر والشام مركزا للتجارة العالمية والطريق الرئيسي لتجارة الشرق وبوابة العبور الى أوروبا… لقد تركوا لنا ما يكفي للبرهنة على عظم تاريخهم ومآثر فذة لا يجب بأي حال من الأحوال ان تتوارى في ظلمات التاريخ.
(الكنز المفقود بين رواية شهود وروعة المشهود)
سلطنة المماليك البرجية
الجزء الثاني من الكتاب خصصه المؤلف عن سلطنة المماليك البرجية، التي تعرف أيضًا باسم المماليك الشراكسة، هي المرحلة الثانية من حكم المماليك في مصر والشام، والتي امتدت من عام 784 هـ / 1382 م إلى عام 923 هـ / 1517 م . وقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى المماليك الذين جاءوا من منطقة شركيسيا (تقع في القوقاز)، وتم تجنيدهم في الجيش المصري بعد أن تم استقدامهم كأسرى أو عبيد، وتلقوا تدريبًا عسكريًا صارمًا. تُسمى بالبرجية لأن المماليك الشراكسة كانوا يقيمون في أبراج قلعة صلاح الدين بالقاهرة.
بدأت سلطنة المماليك البرجية عندما أسقط الظاهر برقوق وهو أول سلاطينهم، حكم المماليك البحرية واستولى على العرش عام 1382م.
حول هذه الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ الإسلام بصفة عامة والدولة المملوكية بصفة خاص، جاء كتاب: (سلطنة المماليك البرجية) للباحث السعودي الدكتور عصام علي أحمد ليسلط الضوء حول هذه الحقبة التاريخية الهامة..
ووفقا للمؤلف مثلت سلطنة المماليك البرجية مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي، حيث ظلت تشكل حاجزًا ضد الغزو المغولي المتبقي، وقاومت المد العثماني حتى سقوطها. كما أنها تركت إرثًا معماريًا وثقافيًا يعكس عظمتها في تلك الفترة.
يقول المؤلف في تقديمه لهذا الكتاب: “فبالله أشرع وبه استعين في نشر تايخ سلطنة المماليك البرجية في هذا الكتاب كما كتبه الأولون مع التأكيد على الاحتفاظ بالأسلوب الذي كتبت به دون تغيير حتى يبقى عبق التاريخ يفوح بين كلماته والتي وجدتُ خلالها الحنين الى الاهل الذين سبقونا وعاشوا في زمن ليته يعود في عزه وشموخه وكرامته وحضارته التي نافست العالم أجمع وأبقيت ما ورد في هذه المؤلفات باللهجة العامية او بالطريقة اللفظية التي وردت رغبة في إبقاء عبق تلك الأيام يفوح من بين الكلمات والاسطر ليعيش القارئ في ذلك الزمن الذي مر على البلاد العربية والإسلامية وليستشعر دقائق تلك الفترة وكأنه واحدا من اهل ذلك الزمان.

فجئت بين يديك بكنز ومشكاة نور مملوءة بحيثيات تلك الفترة ومجرياتها وتطوراتها سلما وحربا ويوميات سلاطين المماليك البرجية واخبارهم واخبار رجالات الدولة العسكريين والاداريين والدينيين والعلماء وعامة الناس، وأخبار العجائب والغرائب والنوادر والطرائف وللحياة العمرانية والاقتصادية التجارية والزراعية وللمناخ واحوال الطبيعة من الزلازل والسيول والنكبات وحالات الكسوف والخسوف”.
نشأة الممالك البرجية
لقد أكثر السلطان قلاوون من شراء الممالك الجراكسة وانزلهم في أبراج القلعة بالقاهرة ليبعدهم عن الاتصال بسكان البلاد، ومن هنا جاءت تسميتهم بـ”المماليك البرجية” وكان هدف السلطان من جلب المماليك الجدد هو أن يكوّن فرقة جديدة من المماليك يعتمد عليها ضد منافسيه من كبار مماليك الاتراك ولتكون سندا له لدوام الملك له في ذريته من بعده في مصر بلاد الشام لذك رأى ان تكون هذه الفرقة من جنس آخر غير الاجناس التي كانت تتألف منها مماليك مصر، فأعرض عن شراء الاتراك والتتار والتركمان وأقبل على المماليك الجراكسة الذين كانوا ينتمون الى بلاد الكرج والقوقاز ما بين البحر الأسود وبحر قزوين.
اتصف المماليك الجراكسة بجمال الصورة وقوة الجسد والشجاع وقد خدموا أسرة قلاوون وأخلصوا لها ودافعوا عنها.
وعندما ازداد عدد المماليك الجراكسة وقويت شوكتهم صار لهم رأي مسموع في انتخاب السلاطين، لكنهم لم يتجرؤوا على طلب السلطة لأنفسهم.
بدأ الخلاف بين المماليك الاتراك والجراكسة في عهد السلطات الاشرف شعبان بن حسين وانتشرت الاضطرابات بعد مقتله وبعد سكون الفتنة نزل المماليك الجراكسة من القلعة ونفى قسم منهم الى بلاد الشام إلا أن الامي برقوق وهو احد المماليك الجراكسة استطاع بفضل ذكائه وطموحه أن يصل الى مرتبة أتباك العسكر وكان يحكم مصر في ذلك الوقت السلطان علاء الدين على أحد أحفاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكان عمره لا يتجاوز الثامنة.
لقد كان باستطاعة الأمير برقوق ان يزيح حفيد الناصر عن عرشه ويحل مكانه إلا ان عائلة قلاوون كان لها منزلة خاصة في نفوس الشعب ذلك لان العصر الذي حكمت فيه كان يمثل ازدهار اقتصادي وأمني وعلمي.
ولا شك ان الفضل في ذلك الوقت يعود الى السلطان قلاوون في إرساء هيبة الحكم وإحاطة اسم اسرته بهالة من المجد، لذلك احتفظت هذه الاسرة بمنصب السلطنة حتى أواخر القرن الثامن للهجرة.
النظام الإداري
تم تقسيم مصر في عصر المماليك البرجية الى عدد من المناطق الإدارية تألفت من ثلاث عواصم وهي: مدينة الفسطاط ومدينة القاهرة والقلعة وتم تقسيم الديار المصرية الى وجهين قبلي وبحري.
وشهد عصر المماليك نظاما ادرايا بالغ الدقة ونهض في ذلك النظام مجموعة كبيرة من الموظفين وانقسموا الى قسمين هما: أرباب السيوف وارباب القلم، أرباب السيوف من طبقة المماليك وارباب القلم من طائفة المعممين المصريين المشتغلين بالكتابة والعالم.
وهذا الجهاز الإداري اعتمد على مجموعة من الدواوين الكبيرة لإدارة الدولة والدواوين هي مكان السجلات وهي اشبه بالوزارات اليوم.
الشام
وفي الشام كانت نيابة حلب تتمتع بأهمية خاصة في عصر المماليك نظرا لخطورة موقعها على الأطراف الشمالية لدولة المماليك مما جعلها محورا لكثير من الاحداث والعلاقات المضطربة بين المماليك من ناحية والتركمان من ناحية أخرى.
اعتمد النظام السياسي على القوة العسكرية، حيث كان السلطان عادةً من أقوى القادة العسكريين، ولم يكن الحكم وراثيًا.
شهدت السلطنة البرجية تطورًا اقتصاديًا من خلال سيطرتها على طرق التجارة، لكنها واجهت أزمات مالية في فترات لاحقة بسبب اكتشاف البرتغاليين طرقًا بحرية جديدة أضعفت التجارة المملوكية.
العلم والعمران
برع المماليك البرجية في العمارة الإسلامية، وشهدت فترة حكمهم بناء العديد من المساجد والمدارس والأسبلة، التي تميزت بالفخامة والزخارف الدقيقة.
ومن جانب اخر زخر عصر المماليك بتعدد وتنوع العلماء، يذكر منه المؤلف ابن خلدون صاحب المقدمة والتاريخ المشهورين، وكمال الدين محمد بن موسى الدميري من فقهاء الشافعية وعلى بن عبد الله الغزولي، ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي وشمس الدين أبو الخير محمد الشهير بان الجزري وتقى الدين المقريزي والابشيهي وتقي الدين بن القاضي شهبة أبو بكر بن احمد وابن حجر العسقلاني والسخاوي).
الحياة العسكرية
كان الجيش المملوكي أساس الحكم، واشتهر باستخدام الخيول، والرماح، والسيوف بكفاءة عالية.
أبرز سلاطين المماليك البرجية: (المؤسس الظاهر برقوق. الظاهر جقمق. الأشرف برسباي الذي انتصر في معركة قبرص. الظاهر قانصوه الغوري آخر سلاطينهم الفعليين).
تعرض المماليك الشراكسة لضغوط خارجية كبيرة، خاصة مع بروز الدولة العثمانية كقوة عظمى في المنطقة.
انتهت سلطنتهم بهزيمة السلطان طومان باي أمام السلطان العثماني سليم الأول في معركة الريدانية عام 1517 م.
الخاتمة
يختتم المؤلف كتابه بصورة قلمية بديعة حيث يقول: “ومع انتهاء دولة المماليك وسقوطها تبدو لنا الحضارة الإسلامية كالخضم المحيط قد صبت فيه بعد طول جريان انهار وروافد كثيرة جلبت مع مياهها حمولا طيبة وغثاء طافيا وكانت الشمس تجنح فوق ذلك الحيط الخضم نحو الغروب وتركه يستنير بسنا النجوم ومن ذلك البحر اللجي الواسع السحيق الأغوار والمعتلج الأمواج انبجست ينابيع شتى متدفقة في العلوم والصنائع والإصلاح جرت في أرض أُنُف متفاوتة في أوروبا سنا فجر جديد ثم في ضوء شمس مشرقة ولكنها آلت إليه من اتجاه مادي صرف وتخبط في السيطرة والعنصرية. (وتلك الأيام نداولها بين الناس)”.
يُعد الكتاب مرجعًا هامًا لفهم واستيعاب حقبة مهمة ساهمت في تشكيل ملامح التاريخ الإسلامي، حيث يُمكن للباحثين وطلاب التاريخ الاعتماد عليه كمصدر شامل لفهم طبيعة سلطنة المماليك البحرية وأثرها. يُسهم الكتاب أيضًا في سد فجوات معرفية تخص هذا الموضوع.
باختصار، يُمكن وصف الكتاب كما يقول مؤلفه بأنه “كنز مفقود” يُعيد إحياء حقبة تاريخية غنية، بأسلوب علمي وشهادات موثوقة. ونوصى بقراءة الكتاب لكل المهتمين بالتاريخ الإسلامي عمومًا، والباحثين في تاريخ المماليك خصوصًا.