شخصيات فنيةمبدعون
زينب عبد العزيز .. والوجه المشرق لسيناء

– تحتل الدكتورة زينب عب العزيز بين صفوف فنانينا المعاصرين مقاما مرموقا كمصورة “مناظر طبيعية”، وهى تؤكد ذلك فى لوحاتها عن “سيناء” بل إنها فى هذه اللوحات تخطو خطوة أكبر من حيث السيطرة على أدوات التعبير، والتغلغل إلى ما وراء السطوح والأشكال، لمعايشة الأعماق والجوهر.
– أربعون لوحة بالألوان الزيتية، شاهدتها لزينب عبد العزيز حصيلة ثلاث رحلات قصار إلى “سيناء”. ولئن كانت الرحلات إلى هناك كثيرة ، إلا أن المهم بالنسبة للفنان المبدع هو التقاط روح المكان. وهذا ما حققته زينب عبد العزيز فى أعمال هذا المعرض، وسوف تشعر من مطالعة اللوحات أنك ترجو لنفسك أن تذهب إلى سيناء، وتنغرس جذورك فى رمالها، وتنمو نخلة من نخيل “وادى فيران”، ومويجة على شاطئ “حمام فرعون”، أو صخرة شامخة فى بدن جبل صامد صلب، أو إذا منّ الله عليك بنعمته تضحى شعاعا من الضياء المشرق عند أعلى قمم “جبل موسى”.
رسومات زينب عبد العزيز
– وماذا رسمت زينب عبد العزيز؟ رملا، وصخرا، وبحرا، وجبالا ونخيلا، وقليلة من البشر، وضياء وعلى الأخص ضياء! إن سيناء فى عينى الفنانة هى أرض النور، ففى البدء كانت والكلمة، والكلمة كانت نورا، والنور انبثق من هنا، من أعماق سيناء. من عندنا تحرك ركب الحضارات وآن لها أن تعود.
– ليست هذه اللوحات دعوة فحسب إلى زيارة سيناء، بل إلى الإحساس بها فى داخلنا. وسوف نهتف أمام بعض الأماكن من خلال لوحات زينب عبد العزيز “هذا هو المكان الذى به سرت روحى”.
– تشرق الشمس، فتكسو الرمال المنبسطة بالذهب، وتطل من وراء الجبال المترامية تتلمس القمم بلمسات من التبر المذاب، وتمضى صاعدة إلى عرشها السماوى فتسطع الدنيا كلها بضياء، فى بعض الأحيان حارقة، تسود لها جذوع النخيل وقامات البشر، وفى بعض الأحيان تشعر كأن الشمس قد بعثت أشعتها من عليائها، تلهو على الرمال الساجية على الشطئان الزرقاء، سواء فى العريش أو فى شرم الشيخ (ذهب، نوبيع، قرية الصيادين).
– تشرق الشمس، فتكسو الرمال المنبسطة بالذهب، وتطل من وراء الجبال المترامية تتلمس القمم بلمسات من التبر المذاب، وتمضى صاعدة إلى عرشها السماوى فتسطع الدنيا كلها بضياء، فى بعض الأحيان حارقة، تسود لها جذوع النخيل وقامات البشر، وفى بعض الأحيان تشعر كأن الشمس قد بعثت أشعتها من عليائها، تلهو على الرمال الساجية على الشطئان الزرقاء، سواء فى العريش أو فى شرم الشيخ (ذهب، نوبيع، قرية الصيادين).

سيناء مملكة النور
– تشعر زينب عبد العزيز فى سيناء بأنها “مملكة النور” ولئن كان الضوء يأتى عادة إلى الأشياء من خارجها، إلا أنه فى سيناء نابع من الداخل من الأعماق، إنه الجانب الروحانى فى الطبيعة وفينا، ومن خلاله نتحاور مع الوجود وحتى الليل في سيناء، رغم هبته، مضئ.. فالقمر هناك واضح منير، والنجوم فى عليائها أيضا لامعات لأن الجو صاف خلا من كل تلوث وعوادم “وفى ضوء القمر تتشكل الموجودات” وتشعر بأنك تحيا فى أحضان “طبيعة إنسية” فتتحول الصخور على الأخص إلى “هيئات آدمية” تحرك فى النفس المرهفة شتى الخيالات.
الشروق على قمم جبل موسى
– ويصل فن زينب عبد العزيز إلى أوجه فى لوحتها الكبيرة “الشروق على قمم جبل موسى”، أربع ساعات من الصعود عبر دروب وعرة، فى عتمة الغسق المندحرة، كى تدرك لحظة الشروق، وهى لحظة نسيت فى وجداناتنا المتحجرة نحن الذين طمست عمائر المدينة بصائرنا، وخنق الأسفلت بكورتنا، تحت ركامات آن الأوان أن ننفضها عن كواهلنا. بعد أن عادت سيناء إلينا. وهناك حيث صعدت بنا الفنانة فى رحلة حجيج إلى “منابع النور” نسمع هسيس الريح يهمس إلينا بشتى الترانيم والأهازيج، معبقة بأريج الخلاء. ويبدو جمال الطبيعة الضارى متسر بلا بغلالات الليل السوداء البنفسجية الزرقاء، وتلامس القمم الشوامخ هامات السحب وتتحاور معها حول “لغز الأبدية” وإذا كانت تساءلت يوما “أين تذهب الروح؟” فالمنظر بجلاله وسكينته يعطيك إجابة تطرح عن كاهلك الهموم، وتشعر أنك ولدت من جديد.. فقد انحسر عنك جرمك الطينى، وأضحيت بدورك أثيرا تسبح لخالق السموات والأرض. ومن أعماق هذا المنظر الذى يبدو كما لو كان لا ينتمى إلى أرض البشر، تبزغ شمس الصباح، تنفث ضياءها حانية فى أرجاء السحب، ولا تلبث أن تكسو سفوح الجبال بلمسات الذهب.

– وربما كانت أقرب لوحات زينب عبد العزيز السابقة إلى لوحاتها عن سيناء هى لوحات مرحلة التفرغ سنتى 71و1972 لرسم النوبة وأسوان. ولولا الخلفية الواسعة التى عاشتها الفنانة آنذاك لما استطاعت أن تصل إلى التعبير عن سيناء بهذا النضج. على أنه بمقارنة لوحات كل من المرحلتين بلوحات المرحلة الأخرى، يبين أن معايشة الناس فى النوبة كانت متاحة على نحو أكبر منها فى سيناء، التى بحسب أصلها التاريخى مكان للتعبد والعزلة ولهذا كان الإحساس بالخلوة وبضراوة الطبيعة أكبر فى لوحات سيناء منه فى لوحات النوبة. إنك تحس فى سيناء بأنك وربك على صلة وطيدة، وأنكما على وفاق. وأول ما يمكنك أن تنطق به أمام طبيعة سيناء – على حد قول زينب عبد العزيز هو ` ما أبدعك يا ربى! وما أبدع صنائعك!. “إنك فنان عظيم”.
زينب عبد العزيز وهمس الألوان والأضواء
– وعندما يطول التأمل، فى السكون الممتد، وتتطهر الأذن فى الصمت المكين من الثرثرات الجوفاء ولرد القول، يبدأ الفنان فى اكتشاف صحراء أخرى، وبخاصة عندما يخفت الضوء فى الغسق، أو عندما يطلع القمر يمشى الهو بنا فى السماء وحيدا، يسكب على الجبال والوديان والسهول فضته الحانية. يغتسل الكون ويزيح النقاب أن محياه ( ) وفى ألفته بالفنان يبين عن رومانسيته كثيرا ما تنعكس على لوحات زينب عبد العزيز، وتتشكل الصخور والسحب بأعلى القمم، والظلال على طنافس الرمال بشتى الرؤى، وتهمس الألوان والأضواء بما هو أبعد من واقعها، وتشيع فى أرجاء اللوحات أنغام من موسيقى، تصطخب ضراوة فى بعض الأحيان، وتذوب رقة ووداعة فى أغلب الأحيان، وفى أحيان أخرى تعزف الفرشاة وبلا افتعال أنغاما من قبل ما جاشت به وجدانات أساطين الموسيقى على مدى الأزمان، ولكن لا عجب إذ أن النبع الصافى لكل ما هو من الفنون رفيع الشأن نبع واحد. وسيناء دواة عريقة ومقدسة لو غمست ريشتك بيقين فى أحبارها لدبجت من الكلمات والأنغام والتصاوير أحلاها. ومبارك من عرف السر، الذى لا يعطى إلا للمختارين، الذين يصعدون الدرج الشاق وبصفاء النفس ويعلمون، وكان من حظ زينب عبد العزيز أن تكون واحدة من هؤلاء، وهى لم تصعد بيسر أو تقفز الدرجات قفزا، بل سنين تلو سنين وهبت هذه الفنانة فرشاتها للطبيعة، وراحت فى محرابها تتعبد، تنحنى لقوانينها إكبارا عندما تسجلها، وبوله ترصد دقائقها. تغنى أغنيتها فلا تفتعل أو تشتط. مطواعة هى مثل العشب النضر يميل مع النسيم عندما يهب على البستان أو الحقل، وبتواضع الحكماء راحت تذوب فى الطبيعة، ترتمى بين أحضانها فتضحى مع النهر قطرة من مائة، ومع الشجر ورقة على غصن، ومع العصفور ريشة فى جناحه، ومع الصحراء ذرة من رمالها. هذا هو الدرس الذى يمكن أن تعطيه لنا “المحاكاة الواقعية للطبيعة” عند زينب عبد العزيز، فهى لا تستعلى، وعلى “الكنز الإلهى” تحافظ ولا تعمد إلى تبديده. إنها “تعيش” الطبيعة ولا تفصل نفسها عنها. تسجل ولا تقحم نفسها فيما تسجل. تعرف كيف تتوارى وراء عملها باستيحاء وتواضع ومودة. تصمت وتترك لوحتها تتكلم عن موضوعها كلاما يتصف بالوضوح والبلاغة وسرعة النفاذ إلى القلب. ولهذا كان تفاعل الجمهور بفنها تفاعلا بناء شديد الحماس. وهو ما يجعلها تشعر – على حد قولها – “المزيد من الرهبة كلما أمسكت الفرشاة”.

– وقد لقيت الطبيعة من الفنانين مواقف مختلفة، فمن الفنانين من يفرضون شخصيتهم عليها، فيأتى تعبيرهم عنها كثير الادعاء مفتعلا. ومنهم من يعمل فى صورتها تشويهات أو تحريفات، فيلوون بذلك عنقها لويا تبدو معه على ما ليست عليه مكرهة. ومنهم أيضا من يتخذها مطية للدعاية عن أفكار ومفاهيم غير متجانسة معها، فتبدو كملك فى ثياب مهرج أو داعر فى مسوح النساك. ومنهم من لا يحاكى الطبيعة، إلا فى ناحية واحدة هى قدرتها على التخليق فيمضون من هذا المنطلق يلعبون، وهى – أى الطبيعة – فى كل الأحوال لا تلعب. ولم تكن زينب عبد العزيز من هولاء، فموقفها من الطبيعة يخلو من كل `ضدية` أو `غيرية` بل إنها فى مقالاتها النقدية راحت تكشف عن زيف وفقر الكثير من الأعمال الحديثة المفتعلة باسم التجريب والحداثة، وظلت وفية للرؤية الواقعية للطبيعة.
– وما كان أسهل أن تنجرف زينب عبد العزيز من خلال دراساتها للفنون الأوربية والأمريكية وزيارتها لعواصم الفن بالخارج إلى `الطليعية` و`الحداثة` فما أيسر تقليد هذه الأعمال والكسب السريع للشهرة، ولكنها نزهت نفسها عن ذلك، واختارت الطريق الصعب. وكان خير عاصم لها أنها تتلمذت على يدى شريك حياتها المرحوم الفنان لطفى الطنبولى، الذى تكن له كل الحب والتقدير كأستاذ وزوج وصديق، فقد كان لطفى الطنبولى بدوره فنانا مخلصا لطبيعة بلاده، وأتاح لزوجته من خلال عمله فى قطاع الآثار عدة زيارات لأقاليم مصر منها النوبة والأقصر وأسوان، حيث صورت زينب عبد العزيز إلى جوار زوجها الكثير من المناظر الطبيعية فى تلك الأماكن.
وما تذكره له دواما كأستاذ أنه كان يصر “أن تكون هى، ولا تتأثر بأى فنان آخر، حتى هو”.
– وقد بدأت زينب عبد العزيز ترسم منذ الصغر، بل وعلى حد قولها “قبل أن تتعلم الكتابة”. وقد مضى فنها يتطور بخطى متصلة ترمى إلى التعبير عن الواقع الذى تعيشه – ذاتيا وخارجيا – بأوضح وأبسط شكل ممكن وكانت الموسيقى من الفنون التى عشقتها ومارستها فى الصغر من عزف على البيانو، وغناء، وباليه. وهى أم لأستاذ فى الموسيقى الكلاسيك تخصص وحصل على الدكتوراه فى العزف على آلة “الفيولا ” وهى تحب الموسيقى الكلاسيكية، ولا تطيق صخب ما يسمونه “الديسكو” وما شابهه، فهذه عمليات تحطيم حاسة الإنسان تحت شعار “العصرية” وبحكم اهتمامات زينب عبد العزيز فالقراءات التى تروق لها متعددة الجوانب وارتباطها بالفنون ومتابعة تطورها لم يمنعها من متابعة فتوحات القرن العشرين أيضا.
– وقد بدأت زينب عبد العزيز ترسم منذ الصغر، بل وعلى حد قولها “قبل أن تتعلم الكتابة”. وقد مضى فنها يتطور بخطى متصلة ترمى إلى التعبير عن الواقع الذى تعيشه – ذاتيا وخارجيا – بأوضح وأبسط شكل ممكن وكانت الموسيقى من الفنون التى عشقتها ومارستها فى الصغر من عزف على البيانو، وغناء، وباليه. وهى أم لأستاذ فى الموسيقى الكلاسيك تخصص وحصل على الدكتوراه فى العزف على آلة “الفيولا ” وهى تحب الموسيقى الكلاسيكية، ولا تطيق صخب ما يسمونه “الديسكو” وما شابهه، فهذه عمليات تحطيم حاسة الإنسان تحت شعار “العصرية” وبحكم اهتمامات زينب عبد العزيز فالقراءات التى تروق لها متعددة الجوانب وارتباطها بالفنون ومتابعة تطورها لم يمنعها من متابعة فتوحات القرن العشرين أيضا.
– ولدت بمدينة الإسكندرية فى التاسع عشر من يناير 1935، حيث أمضت المرحلة الابتدائية من تعليمها بمدرسة “سان جوزيف” بمحرم بك ثم المرحلة الثانوية “بالليسيه فرانسية” بالشاطبى وتخرجت من قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1962.
وعملت مذيعة ومقدمة برامج فى التلفزيون فور تخرجها ولبضعة أشهر. ثم عينت مترجمة فى مركز تسجيل الآثار المصرية ومنه إنتقلت إلى كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فور حصولها على الدكتوراه. ولا زالت تعمل هناك حيث تشغل وظيفة أستاذ لمادة الحضارة.

معارض زينب عبد العزيز
– وقد اشتركت زينب عبد العزيز فى المعارض العامة منذ عام 1955 كالصالون والربيع، وأقامت ثلاثين معرضا خاصا فى مصر والخارج ورغم تحمسها لفكرة الاستمرارية إلا أن الظروف الاجتماعية التى تعيشها واضطرارها لشغل وظيفة جامعية لا تسمح لها بالإنتاج المتواصل وكم كانت تتمنى أن تتفرغ لفنها، وألا تعمل شيئا سوى الرسم والكتابة، فالعمل المتواصل، حتى وإن اعترته بعض فترات التوقف هو البوتقة التى تصقل فيها نفس الفنان. وتغرى فترات التوقف التى مرت بها الفنانة إلى التزامها بإنجاز أعمال أخرى مثل اتمام رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الخاصة بالدرجات العلمية وهذه أعمال لا تحتمل تأخيراً، وتقتطع من المشتغل بها وقتا ليس بالقليل.
– وموقف الدكتورة زينب عبد العزيز الفلسفى من الحياة – على حد قولها -هى أن تعيشها بكل الصدق الإنسانى الذى تشعر به. والروابط بين الإنسان والكون المحيط به كثيرة ومتعددة، إلا أنه لم يلتفت بفهم إلا إلى الجزء المادى منها، بينما المجتمع الإنسانى بحاجة ملحة ومطردة إلى الالتفات للجانب الآخر ليحصل على الاتزان اللازم، `كلنا عابر وسبيل، حتى الوجود نفسه فالحياة مرحلة من مراحل تطور الكائنات بأسرها، من الإنسان الذى هو أسمى بما فيها حتى ذرات التراب` هذا ما تقوله الفنانة أستاذة الحضارة بجامعة الأزهر وتؤكد بفرشاتها وقلمها.
– وثمة ترابط موضوعى بين فن زينب عبد العزيز والفن المصرى القديم بمعنى أنه استمرار لذات الفكرة التى قام عليها الفن المصرى القديم وليس تقليدا لشكلياته الخارجية، فالفن الفرعونى قائم على فكرة خلود القيمة الجمالية ووضوح الرؤية والبساطة فى التعبير. وهذه هى الدعائم ذاتها التى تقيم عليها زينب عبد العزيز فنها. ولئن كان ثمة ضرورة أن يلقى الفنان نظرة إلى الوراء إلى جذوره، ليستمد من تراثه المعالم الأساسية التى يبنى عليها تعبيره الفنى، إلا أن استلهام التراث لا يعنى محاكاته، فالتقليد لا يخلق فنا، ولا يبعث إلى الحياة تراثا. ولكن الدعوة إلى أن يكون الفنان ابن عصر لا تعنى أيضا محاكاة الأنماط المستوردة أو المفروضة وتقليدها، بل تعنى فى نظر زينب عبد العزيز – إن أخذت هذه الدعوة محمل الجد والأمانة – أن يكون التعبير عن الواقع المعاصر للفنان من خلال الارتباط ببيئته ومجتمعه الأصلى. وليس أدل على ذلك من العودة حاليا فى بلدان أوروبا إلى التراث الخاص بكل بلد بعد `موجة التجريدات العامة` التى طمست معالم الحضارة والتراث المميزة لكل منها. ولعله يجدر بالفنان المعاصر أيضا أن يدخل بسمة بهجة أو يطبع لمسة حب على قلب إنسان هذا العصر المطحون الغارق فى غياهب الزيت والظلمات، وهو إن نجح فى ذلك يكون قد استطاع أن يحقق شيئا كبيرا.
– إن الحضارة هى أجمل ما أحرزه الإنسان من تطور فى كافة المجالات وتقدم الإنسان هو أسمى المخلوقات رغم كل ما يعترى بعض النماذج من عتامة نفسية تعوق تطورها الإنسانى ورقيها. ومصير الإنسان هو الفهم. والمزيد من الفهم، مهما طال به الأمد. ولكن ما يحزن حقا فى نظر الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذة العلوم الإنسانية هو الوقت الذى يحتاجه الإنسان لكى يفهم.
-عندما تتزاحم العمائر فى المدينة وتأخذ بخناق الفنان، يتوق إلى كسر هذا الإسار الذى استحال دمامة مستحوذة، يتوق إلى الخروج، إلى الابتعاد، وإذا كان الفنان فى بلاد أخرى يخرج إلى الجبال أو الغابات أو البحر فإن الفنان فى مصر يجد الصحراء تحيطه فيهرع إليها، ويغسل فى رحابتها عينيه من أدران المدينة، وروحه من وعثائها. وهو بذلك يلبى نداء عميقا دفينا يظل يهمس إليه ويدعوه إلى أن يشحذ همسته التى أضحت خائرة من جراء حياة الدعة فى الغرف المعتادة المغلقة وينطلق إلى حيث الضياء والهواء والرحابة.
الاختلاء بالطبيعة
– يختلى الفنان فى سيناء بالطبيعة، رمال، وصخور ونخيل، ومياه، وقليل من البشر والأبل، فيستطيع أن يستمع إلى أنفاسها وهمساتها وأدق نبضاتها، وللطبيعة أنفاس وهمسات ونبضات بحق، وليس ذلك من قبل المجاز أو الخيال، ولكن يجب أن تكون مرهف الحس كى تسمع ذلك الدبيب، والوجيب، والنداء.
– وليس ارتباط زينب عبد العزيز بالطبيعة جديدا فهو ممتد منذ طفولتها وتقول إنها كانت وهى طفلة تفرح بالطبيعة كأنها تذهب للقاء شخص حبيب. وحتى عندما شبت عن الطوق ومارست الفن فإن الطبيعة كانت تثير فى أعماقها انعكاسات ودوافع إلى الإبداع. ومن ثم كانت الطبيعةعندها نقطة انطلاق. وعند التقائها بالصحراء فى الصغر كانت لا تقاوم رغبة الاندفاع إلى أحضانها. وقد يعتقد البعض أن الصحراء ساحتها تشغلها رمال فحسب، ولكن الفنانة اكتشفت بعد تكرار زيارتها للصحراء، أن لكل بقعة فى الصحراء شخصيتها وجوّها وألوانها. تذكر زينب عبد العزيز ابنها عندما ذهبت فى الخمسينات إلى النوبة توغلت ذات مرة فى صحرائها حتى تاهت فى منطقة كانت تسمى `وادى الجماجم` وقد رسمتها فى إحدى لوحاتها. المكان جبل فى صخوره ما يشبه الجماجم “اسم على مسمى” مكان مغلق مخنوق. وهكذا تتنوع شخصية المكان فى الصحراء ولا تتكرر. وبصفة عامة تقول الفنانة إن الصحراء على الدوام تشدها، وتتجاوب معها، وتشعر أن فيها شيئا منها، فلا تحس اغترابا فى الصحراء رغم ما فيها من صمت ووحشة. بل إن الأصداء هناك تفد إليها ملونة، ومتنوعة المعانى. وربما أمكن أن نترجم أحد هذه المعانى إلى نداء بالذهاب إليها وتعميرها. وفى رحابة الصحراء لا تسمع صوتا بشريا بل هسيسا يحب وينادى. أما الإحساس فى الصحراء بالله فقوى وغامر، تتلاشى ذبذبات الأنانية ويشعرك الصفاء والزهد أنك تجردت من كل الأثقال التى تعوقك من الصعود إلى الحضرة الإلهية.
– فى منطقة العريش تلتقى بكثبان الرمال بالغة النعومة تمتد أمامك متراقصة فى خطوط إنسيابية. فإذا نزحت إلى الجنوب بدءا من الطور إلى شرم الشيخ ونوبيع وطابا وجزيرة فرعون فستلتقى بتكوينات صخرية. فإذا توغلت فى داخل سيناء إلى جبل موسى وسانت كاترين ووادى قيران فستجد بحوراً من القمم الجبلية تمتد إلى ما لا نهاية والظلال فى سيناء لها معنى، وتحس كأنك فى حمى روح كبيرة تبسط عليك جناحيها.
– وبالنسبة للجنوب على الأخص حيث ترتفع القمم العنيدة الشامخة إلى ما قد يصل أحيانا إلى ألفين وثمانمائة متر تكتسى مناظر الجبال والصخور رهبة وخشونة وصلابة، ويختلف طابعهاوانعكاساتهاعن كثبان الرمال فى العريش ثم هناك فى الجنوب تلتقى عيناك بشفافية قد لا تخطر لك على البال وذلك فى مياه البحر الأحمر. وقد تطلبت عملية التوفيق بين سخونة الألوان وصلابة الصخور وشفافية المياه هناك نوعية أخرى من المعالجة.
– وبخلاف الانطباع الجمالى والحوار النفسى فإن كل منطقة من سيناء راحت تمثل بالنسبة للفنانة مشكلة المعالجة، أو بعبارة أخرى مشكلة التعبير عما تراه وتستشعره. ومع مراعاة أن الضوء يلعب دوراً أساسيا فى مشاهد سيناء فإن الضوء يتنوع بتنوع المناطق، ويختلف باختلاف البقاع التى ارتادتها الفنانة بفرشاتها. ففى منطقة العريش على سبيل المثال كان على الفنانة أن تجد المعادل اللونى المناسب لنعومة الرمال، وأثيرية الهواء، والنخيل ذات الظلال الممتدة. واستحوذت على الفنانة الرغبة فى التعبير بخامة الزيت الصلبة عن الشفافية التى تتيحها الألوان المائية.
– ثم هناك الألوان فى الأزياء الشعبية. كل قرية تتميز بطابع معين من الملابس ذات الألوان الحمراء والبنفسجية والسوداء. وتارة كل الألوان فى زى واحد.
– وتختلف مشاهد سيناء عن مشاهد الصحارى الأخرى فى النوبة وأسوان ومرسى مطروح وبرج العرب، وذلك تبعا للتكوين والضوء وبالتالى المعالجة. وبالنسبة لسيناء يضاف إلى مشاهدها أيضا البعد التاريخى، والحضارى، والروحى.
– وقد رسمت زينب عبد العزيز من قبل صحارى الدلتا ما بين مصر والإسكندرية ورسمت برج العرب ومرسى مطروح، ورسمت صحارى أسوان والنوبة، ثم رسمت صحارى سيناء. ويمكن القول بصفة عامة أنه ما من لوحة تكرر أو تعوض الأخرى وهو ما يدل على ثراء الطبيعة، وعلى صدق صيحة الفنانة إذ تقول كيف يترك الفنان هذا الثراء، ويحصر فرشاته فى افتعالات صناعية محدودة الأطر. إن العالم فى الخارج قد أحسن فعلا إذ عاد اليوم إلى تعلم الرسم الواقعى من جديد.
– إن الطبيعة فى سيناء تساعد الفنان، إذ أنها سكونيه. ممتدة أمامه بلا تغير، ومن ثم يستطيع الفنان أن يطيل تأمله للطبيعة ويستغرق فيها دون خوف من أن يطرأ على ما أمامه تحول يفسد عليه لوحته. ولعل أكثر العوامل المتحركة على هذا المسرح الثابت هو الضوء، والحوار شديد الثراء بين ذبذبات الفنان والطبيعة، إذ أنه يجد نفسه فى خلوة تامة مع الطبيعة ، ويصل من فرط تأمله لها إلى نوع من التوحد بها، حتى ليكاد يخيل للفنان أنه هو الطبيعة التى من حوله، بل يخيل له أنها فى داخله، وليست فى خارجه حتى إن الفنان قد يستطيع أن يلون ويشكل الطبيعة بألوانه ورؤاه الخاصة، مثلما يغير ويشكل الضوء المنظر الطيعى الواحد فى مختلف ساعات الليل والنهار وهذا ما يحدث مثلا فى سيناء حتى إن الفنان أمام المنظر الواحد لا يمل من رسمه المرة تلو المرة وهو يتلون ويتشكل تبعا لضياء النهار والليل، والموجودات غير راسخة فى مكانها بل هى سابحة مع الزمن ممتدة عبر الأفق المفتوح إلى الأبدية. فإذا ما أقبل الليل وغطى القمر الكون بضيائه فإن الروح تخلع عن وجهها النقاب وتتجلى وضاءة براقة، ومهيبة.
– وتختلف مشاهد سيناء عن مشاهد الصحارى الأخرى فى النوبة وأسوان ومرسى مطروح وبرج العرب، وذلك تبعا للتكوين والضوء وبالتالى المعالجة. وبالنسبة لسيناء يضاف إلى مشاهدها أيضا البعد التاريخى، والحضارى، والروحى.
– وقد رسمت زينب عبد العزيز من قبل صحارى الدلتا ما بين مصر والإسكندرية ورسمت برج العرب ومرسى مطروح، ورسمت صحارى أسوان والنوبة، ثم رسمت صحارى سيناء. ويمكن القول بصفة عامة أنه ما من لوحة تكرر أو تعوض الأخرى وهو ما يدل على ثراء الطبيعة، وعلى صدق صيحة الفنانة إذ تقول كيف يترك الفنان هذا الثراء، ويحصر فرشاته فى افتعالات صناعية محدودة الأطر. إن العالم فى الخارج قد أحسن فعلا إذ عاد اليوم إلى تعلم الرسم الواقعى من جديد.
– إن الطبيعة فى سيناء تساعد الفنان، إذ أنها سكونيه. ممتدة أمامه بلا تغير، ومن ثم يستطيع الفنان أن يطيل تأمله للطبيعة ويستغرق فيها دون خوف من أن يطرأ على ما أمامه تحول يفسد عليه لوحته. ولعل أكثر العوامل المتحركة على هذا المسرح الثابت هو الضوء، والحوار شديد الثراء بين ذبذبات الفنان والطبيعة، إذ أنه يجد نفسه فى خلوة تامة مع الطبيعة ، ويصل من فرط تأمله لها إلى نوع من التوحد بها، حتى ليكاد يخيل للفنان أنه هو الطبيعة التى من حوله، بل يخيل له أنها فى داخله، وليست فى خارجه حتى إن الفنان قد يستطيع أن يلون ويشكل الطبيعة بألوانه ورؤاه الخاصة، مثلما يغير ويشكل الضوء المنظر الطيعى الواحد فى مختلف ساعات الليل والنهار وهذا ما يحدث مثلا فى سيناء حتى إن الفنان أمام المنظر الواحد لا يمل من رسمه المرة تلو المرة وهو يتلون ويتشكل تبعا لضياء النهار والليل، والموجودات غير راسخة فى مكانها بل هى سابحة مع الزمن ممتدة عبر الأفق المفتوح إلى الأبدية. فإذا ما أقبل الليل وغطى القمر الكون بضيائه فإن الروح تخلع عن وجهها النقاب وتتجلى وضاءة براقة، ومهيبة.
سيناء جنة الفنان
– سيناء جنة الفنان حقا ليس ثمة ما يقطع عليه هناك تأملاته وخلوته. كيف كان العالم عند بداية الطبيعة؟ فى البدء كان الخلاء البكارة، وكانت الطبيعة تتربع.
– والصمت فى سيناء ليس كينونة سلبية جوفاء بل فى الصمت ذبذبة حوار وإشعاع داخلى، وفى السكون حركة مضمرة، فالجبال الراسخة تبدو للفنان إذا ما استغرق فى تأملها أنها تتحرك وبخاصة إذا ما سمقت قممها والتحمت السحب.
– ويرتبط رسم الطبيعة والصحراء عند زينب عبد العزيز بموقفها فى الفن. فالواقع المعاصر والارتباط بالبيئة والتراث على ما هو فى اللحظة التى يعيشها الفنان هو الجديد فى الفن، وليس الحيل التكنيكية والألاعيب المكرورة.
– والذى يدعو إلى المزيد من التشبث بسيناء هو أنها رمز إلى معانى كثيرة، فليست سيناء بالموقع العادى من مواقع الوطن ولا حتى من مواقع الدنيا كلها. إنها كانت ولا تزال نداء ينفذ إلى القلوب فيسمو بها ويدعوها إلى التأمل. ولهذا فهذه البقعة الحبيبة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بها من جهات عديدة متنوعة الاهتمامات وليكن إحدى هذه الجهات الفنانين، وحبذا لو أقيم فى سيناء دار لضيافة الفنانين أو مرسم مثل مرسم الأقصر سابقا، يوفد إليه أو يؤمه من الفنانين من يريد أن يزداد تغلغلا فى الطبيعة والتحاما بها، كى يتلقى منها أنفع الدروس لفنه، وفى الصفاء والسكون والتوحد يستقى مفاهيمه عن الجمال الأصيل والمتجرد من الحذلقات والبهارج التى يمكن أن يصيبه به زمن خربته المادة الصماء التى هى من الروح قد خلت، فبغت وتجبرت وساقت البشر إلى حافة الهاوية.
– والصمت فى سيناء ليس كينونة سلبية جوفاء بل فى الصمت ذبذبة حوار وإشعاع داخلى، وفى السكون حركة مضمرة، فالجبال الراسخة تبدو للفنان إذا ما استغرق فى تأملها أنها تتحرك وبخاصة إذا ما سمقت قممها والتحمت السحب.
– ويرتبط رسم الطبيعة والصحراء عند زينب عبد العزيز بموقفها فى الفن. فالواقع المعاصر والارتباط بالبيئة والتراث على ما هو فى اللحظة التى يعيشها الفنان هو الجديد فى الفن، وليس الحيل التكنيكية والألاعيب المكرورة.
– والذى يدعو إلى المزيد من التشبث بسيناء هو أنها رمز إلى معانى كثيرة، فليست سيناء بالموقع العادى من مواقع الوطن ولا حتى من مواقع الدنيا كلها. إنها كانت ولا تزال نداء ينفذ إلى القلوب فيسمو بها ويدعوها إلى التأمل. ولهذا فهذه البقعة الحبيبة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بها من جهات عديدة متنوعة الاهتمامات وليكن إحدى هذه الجهات الفنانين، وحبذا لو أقيم فى سيناء دار لضيافة الفنانين أو مرسم مثل مرسم الأقصر سابقا، يوفد إليه أو يؤمه من الفنانين من يريد أن يزداد تغلغلا فى الطبيعة والتحاما بها، كى يتلقى منها أنفع الدروس لفنه، وفى الصفاء والسكون والتوحد يستقى مفاهيمه عن الجمال الأصيل والمتجرد من الحذلقات والبهارج التى يمكن أن يصيبه به زمن خربته المادة الصماء التى هى من الروح قد خلت، فبغت وتجبرت وساقت البشر إلى حافة الهاوية.
– وتتمنى زينب عبد العزيز أن تكون دائبة الزيارة إلى أرض سيناء، لترى منها مناطق لم تتح لها رؤيتها فى زيارتها الماضية، لقد مرت سريعا ببحيرة البردويل، ومناجم الفحم وسد الروافع والمغاليق ولكن لم يعلق بخيالها من هذه الأماكن إلا أمل فى أن تعود إليها فى المستقبل الذى نود أن تلقى فيه سيناء من أبناء مصر وفنانيها مزيدا من المحبة والاهتمام.
– عودة قبل النهاية إلى مفاهيم زينب عبد العزيز الفنية أنها تتوخى فيما ترسم موضوعية تنم عن مبلغ كبير من الصدق والجدية ومن منطلق الصدق والجدية هذا كثيرا ما تأتى لوحاتها مشربة `بالذاتية` ومفعمة `بالرمزية` وكل ذلك فى إطار `الواقعية `، على الدوام. لقد احتذت زينب عبد العزيز برائد الواقعية فى التصوير الحديث المصور جوستاف كوربيه ( 1819 – 1877 ) الذى كان يكن للطبيعة ـ وعلى الأخص طبيعة قريته أوران ـ أبلغ الحب والتقدير، وفى لوحاته يصل البحر بموجه ورحابته والجبل بصخره وضراوته إلى ذروة الجمال. وعلى الرغم من أنه قال لأحد سائليه إننى لم أرسم ملائكة لأننى لم أر ملاكا، فقد حفلت لوحاته الواقعية بروحانية لا تأتى إلا كفيض من قلب طرح زيف الحذلقات جانبا، وإلى على نفسه ألا يغمس فرشاته إلا فى محبرة الصدق ليسطر قصائد من الألوان والأشكال تبقى على مر الأزمان بقاء كل ما هو شريف ونبيل ومخلص.
– وفى ظلال واقعية جوستاف كوربيه نقرر أن زينب عبد العزيز لم يمنحها الله موهبة التعبير بالخطوط والألوان فحسب بل ونعمة القيام بسياحات بعيدة فى رحاب الفن أيضا من قراءاتها الواعية المستفيضة لتاريخ الفن إيان تحضيرها لرسالتيها لنيل الماجستير والدكتوراه من العلاقة بين الفن والأدب من خلال عبقريتى يوجين ديلاكروا (1798 – 1863 ).رائد الرومانسية وفينسنت فان جوج (1853 – 1890 ) رائد التعبيرية فعرفت أن البقاء فى الفن للأكثر إخلاصا وصدقا ونقاء. وماذا أكثر إخلاصا وصدقا ونقاء من التعمق فى طبيعة بلادها، كما تعمق كوربيه فى طبيعة بلدته أوران، صعودا إلى قسم الروحانية العليا؟. ولكأننا نستمع فى هذا المقام إلى صوت الأديب اليونانى الكبير نيقوس كازندزاكى (1883 – 1957) إذ يقول إنما الروح بالجسد يدرك، فالله من الطين خلق إنسا. زينب عبد العزيز فنانة صادقة مع نفسها، عايشت الطبيعة وانصاعت لها، وراحت تتأملها، وتتقصى عن اتجاهاتها ومظاهرها، وعلى الرغم من أنها فنانة مناظر طبيعية منذ زمن بعيد، اكتشفت فى سيناء جوهرا مكنونا يشع على الموجودات المادة وعلى الطبيعة كلها يفيض، وهذا الجوهر هو الضوء، الضوء النابع من داخل سيناء نفسها، من أعماقها، فسيناء لها تاريخ تليد، واتصال بعيد بالروحانيات والأديان، هى مهبط الأديان السماوية، ومن ثم كان ضوء الطبيعة فى هذا المكان المقدس معادلا للروح، ولنر الجبال فى عديد من لوحاتها ذائبة فى الضوء متأثرة به أبلغ التأثر. بحيث يمكننا أن نقول إن الإضاءة فى هذا المقام `إضاءة روحية` ولكأن الطبيعة فى `لحظة تعبد، ولنرى النخيل بدوره ذائبا فى الإضاءة الرمزية الموحية التى اكتشفتها الفنانة واعتنقتها فى لوحاتها، الإضاءة التى تأكل حواف الأشياء، وأيضا فلتلتفت فى هذه اللوحات إلى الإحساس بالهواء والأثير والرحابة، وبعبارة موجزة ببصمة الخالق على كل مفردات المكان، وليس من السهل على الفنان، إلا بعد اجتياز عديد من الاختبارات والاستحواذ على عديد من الخبرات التوصل إلى المستوى الذى يتعدى الماديات مع البقاء محافظا عليها.
– عودة قبل النهاية إلى مفاهيم زينب عبد العزيز الفنية أنها تتوخى فيما ترسم موضوعية تنم عن مبلغ كبير من الصدق والجدية ومن منطلق الصدق والجدية هذا كثيرا ما تأتى لوحاتها مشربة `بالذاتية` ومفعمة `بالرمزية` وكل ذلك فى إطار `الواقعية `، على الدوام. لقد احتذت زينب عبد العزيز برائد الواقعية فى التصوير الحديث المصور جوستاف كوربيه ( 1819 – 1877 ) الذى كان يكن للطبيعة ـ وعلى الأخص طبيعة قريته أوران ـ أبلغ الحب والتقدير، وفى لوحاته يصل البحر بموجه ورحابته والجبل بصخره وضراوته إلى ذروة الجمال. وعلى الرغم من أنه قال لأحد سائليه إننى لم أرسم ملائكة لأننى لم أر ملاكا، فقد حفلت لوحاته الواقعية بروحانية لا تأتى إلا كفيض من قلب طرح زيف الحذلقات جانبا، وإلى على نفسه ألا يغمس فرشاته إلا فى محبرة الصدق ليسطر قصائد من الألوان والأشكال تبقى على مر الأزمان بقاء كل ما هو شريف ونبيل ومخلص.
– وفى ظلال واقعية جوستاف كوربيه نقرر أن زينب عبد العزيز لم يمنحها الله موهبة التعبير بالخطوط والألوان فحسب بل ونعمة القيام بسياحات بعيدة فى رحاب الفن أيضا من قراءاتها الواعية المستفيضة لتاريخ الفن إيان تحضيرها لرسالتيها لنيل الماجستير والدكتوراه من العلاقة بين الفن والأدب من خلال عبقريتى يوجين ديلاكروا (1798 – 1863 ).رائد الرومانسية وفينسنت فان جوج (1853 – 1890 ) رائد التعبيرية فعرفت أن البقاء فى الفن للأكثر إخلاصا وصدقا ونقاء. وماذا أكثر إخلاصا وصدقا ونقاء من التعمق فى طبيعة بلادها، كما تعمق كوربيه فى طبيعة بلدته أوران، صعودا إلى قسم الروحانية العليا؟. ولكأننا نستمع فى هذا المقام إلى صوت الأديب اليونانى الكبير نيقوس كازندزاكى (1883 – 1957) إذ يقول إنما الروح بالجسد يدرك، فالله من الطين خلق إنسا. زينب عبد العزيز فنانة صادقة مع نفسها، عايشت الطبيعة وانصاعت لها، وراحت تتأملها، وتتقصى عن اتجاهاتها ومظاهرها، وعلى الرغم من أنها فنانة مناظر طبيعية منذ زمن بعيد، اكتشفت فى سيناء جوهرا مكنونا يشع على الموجودات المادة وعلى الطبيعة كلها يفيض، وهذا الجوهر هو الضوء، الضوء النابع من داخل سيناء نفسها، من أعماقها، فسيناء لها تاريخ تليد، واتصال بعيد بالروحانيات والأديان، هى مهبط الأديان السماوية، ومن ثم كان ضوء الطبيعة فى هذا المكان المقدس معادلا للروح، ولنر الجبال فى عديد من لوحاتها ذائبة فى الضوء متأثرة به أبلغ التأثر. بحيث يمكننا أن نقول إن الإضاءة فى هذا المقام `إضاءة روحية` ولكأن الطبيعة فى `لحظة تعبد، ولنرى النخيل بدوره ذائبا فى الإضاءة الرمزية الموحية التى اكتشفتها الفنانة واعتنقتها فى لوحاتها، الإضاءة التى تأكل حواف الأشياء، وأيضا فلتلتفت فى هذه اللوحات إلى الإحساس بالهواء والأثير والرحابة، وبعبارة موجزة ببصمة الخالق على كل مفردات المكان، وليس من السهل على الفنان، إلا بعد اجتياز عديد من الاختبارات والاستحواذ على عديد من الخبرات التوصل إلى المستوى الذى يتعدى الماديات مع البقاء محافظا عليها.
زينب عبد العزيز فنانة صحارى مصر
– وقد سبق أن رسمت زينب عبد العزيز صحارى مصرية أخرى، رسمت صحارى النوبة وقفارها، ولكنها على الدوام كما قلنا تترك نفسها للمكان كى يعبر عن نفسه من خلال فرشاة ألوانها. وهناك فى النوبة، وكانت على وشك أن تغرق، ويغمرها مياه النيل إلى الأبد، تحدثت الصحارى عن القرية والضياع، فالصخرة السوداء وسط الماء وكانت من قبل قمة جبل يحط عليه نسور كأسرة، والزهرة وسط الرمال، والبحيرة والجبل، والزهرة وسط الرمال، والنباتات الوحشية، والسكون المخيم مثل شبح الموت على مرمى البصر، إنما أوحى للفنانة بعالم فى طريقه إلى الأفول، واستمعت فى أرجائه إلى نغمات حزينة لأغنية وداع ضاربة. وذلك كله قد اختلف فى صحارى سيناء. فالأغنية التى تتغنى بها ليست أغنية أقول حزينة، بل أغنية العودة، أهازيج فرح باللقاء بعد غياب، ولئن كانت النوبة القديمة قد غرقت، فسيناء باقية بوجهها المشرق إلى الأبد.
– ومن لوحات زينب عبد العزيز التى لا تنسي عن النوبة لوحتها `صخور وحشية` التى صورتها فى رحلتها الأخيرة إلى هناك. رمال ناعمة فى درجات من البرتقالى نزولا إلى الأصفر، تمضى بك إلى كتل ضاربة من صخور داكنة السواد مشربة بيسير من البنيات وقليل من الأزرق. وتستوقف أنظارها هناك، تحاصرك وتأسرك كما لو كنت إزاء سياج ليس بإمكانك اجتيازه، فتمضى منقادا ثقيل القلب مبهور الأنفاس تتابع تلك الكائنات التى تتشكل منها حواف ذلك السياج القائم عند الأفق المسدود بسفوح تلال لفحها لهيب الشمس مائلة محنية كأنها كائنات تمضى طوابيرها إلى المجهول ويكتمل المنظر بصخرتين عن يمينه ويساره، اتخذت كل منهما هيئة رأس وحش أسطورى ضخم ربما من حيوانات ما قبل التاريخ، بدت عليه أمارات التحفز والإصرار على البقاء مكشرا عن أنيابه متحفزا لمن تسول له نفسه أن يزحزحه عن موقعه أو يدفع به إلى اللحاق بطوابير السائرين إلى العدم.
– وسوف نلاحظ أن هذه الأنسنة للطبيعة ستصاحب زينب عبد العزيز فى مراحلها اللاحقة، ولئن كانت هذه الأنسنة تضفى بصمات رومانسية على بعض لوحاتها، إلا أن هذه الظاهرة تؤكد أيضا حقيقة من حقائق تاريخ الفن تؤمن بها زينب عبد العزيز، وهى أن الإبداعات الجديدة إنما تتخلق عبر عمليات جادة ورصينة من المخاص فليس ثمة ما يمنع من أن تظهر على لوحات فنان واقعى مخلص لفنه أمارات من رومانسية أو تعبيرية أو حتى تجريدية ولكن يجب أن يكون من باب الشطحات التى شاعت فى الفن الحديث، كفقاعات لا تلبث أن تتبدد وتذهب جفاء. وما من شك أن الريح وعوامل التعرية أحسن نحات فى الوجود، يعمل إزميله فى صخور الجبال فتتشكل بأشكال ليس ثمة ما يمنع من أن تبدو مثل هيئات أدمية أو حيوانات.
– وهذا ما حدث فى أرجاء سيناء، فلا يعود الفنان يقف أمام صخر أصم وإنما أمام روح إنسانية تنبض بها الجبال، تلك الجبال التى سمعت مع موسى كلمة الله. ويضحى الفنان فى حضرة ضياء سيناء أمام مناظر نورانية مجردة من الماديات، مناظر تلخص جوهر سيناء وتتفق مع مفهومها الحضارى والفنى والفلسفى عبر التاريخ، وقدد أطلت زينب عبد العزيز من موقفها الفنى الذى ظلت مخلصة له ولموضوعها وهو الطبيعة فرأت ما وراء سيناء، رمالا ونخيلا، وصخورا ومياها وضياء وسكونا، رأت الجانب الروحى، وبسطت ألوانها على قماش لوحاتها على نحو يؤكد هذه الحقيقة “المابعدية” ومن خلال الواقع نفذت إلى ما ليس واقعا، وفى الصمت راحت كما قلنا تتسمع إلى الأصوات التى تشد الوجدان. وهكذا فلئن كانت زينب عبد العزيز قد طرقت فى لوحاتها أماكن أخرى من مصر إلا أنها وجدت فى سيناء الموضوع الذى كانت بحاجة إليه حقا للتعبير عن رؤاها التى تجسمت فيها وتبلورت كل خبراتها السابقة.
بقلم : د./ نعيم عطية
مجلة : إبداع ( العدد 4) أبريل 1987



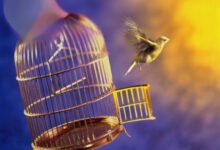

/gi/21.gif)








